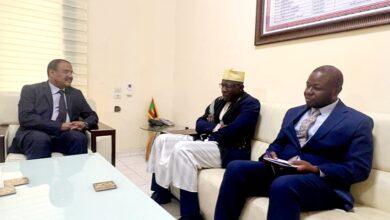الغاز الموريتاني .. نعمة أم نقمة ؟

كنت دائما حائرا في قول المفكر وأخصائي علم المستقبليات المغربي المهدي المنجرة، حينما قال في أبو ظبي عام 1981 ” إن المواد الباطنية المستخرجة من تحت الأرض لا مستقبل لها وان الدول التي تملك المواد الطبيعية قد سخط الله عليها“. فزاد من دهشتي كون الرجل يعرف ما يقول ولا يقول ما لا يعرف. وكلما أسمع أن النفط ظهر في بلدنا ينتابنى اشفاق ممزوج بالخوف من المستقبل..وبمجرد الصدفة أعدت أخيرا قراءة كتاب ادواردو كاليانو الرائع: ”أمريكا اللاتينية التي تنزف“ وكانت المفاجأة، إذ يؤكد بالوقائع تماما ما ذهب إليه د/ المنجرة.
ادواردو كاليانو سرد مأساة أمريكا الجنوبية بدءا بمرحلة الاستعمار الاسباني والبرتغالي حتى النهب المنظم وأحيانا المسلح من طرف الرأسمالية العالمية في الفترة المعاصرة. ولكي نأخذ أولا فكرة عن الكتاب نذكر انه بعد صدوره بسنتين فقط ترجم إلى عشر لغات. ذكر المؤلف في مقابلة صحفية بعد ذلك أن كل ما قالته الصحافة والنقاد من تثمين وتقدير لكتابه لم يؤثر في نفسه بالدرجة التي أثرت بها الحادثة التالية: كان مسافرا في باص بين مدينتين ولا احد يعرف انه هو المؤلف، فإذا بطالبتين بجواره تقرأ إحداهن للأخرى كتابه، وسرعان ما بدأت الطالبتان تبكيان. استمع جميع الركاب لقراءة الكتاب، فبكى البعض في صمت وصرخ الكثير، تأثرا بما جرى على مر العصور لأمريكا اللاتينية وما يجري من نهب وقمع وسيطرة وبؤس وشقاء لا يرجى له فرج. لا يرجى له فرج لأن ادواردو كاليانو وضع على غلاف كتابه كلمة قالها بولفار الذي ناضل مدة حياته من اجل استقلال أمريكا الجنوبية ووحدتها، وفي آخر حياته، بعد أن أدرك حقيقة السيطرة الانكلو-أمريكية قال تلك الجملة الرهيبة: ”لن نكون سعداء، أبدا لن نكون سعداء“.
يفهم من ما ورد في كتاب كاليانو أننا إذا واصلنا في سياستنا الحالية دون تغيير جذري ، فبإمكاننا أن نرى يوما ما مدينة ازويرات الجميلة، والتي أعطت ومازالت تعطي، وهي مهجورة من السكان، لا حركة فيها ولا صوت سوى نبيح الكلاب الضائعة وعويل الذئاب الجائعة! كما أن ظهور النفط في وضعنا القائم قد لا يكون نعمة إلا بشروط هي كالصعود إلى الثريا، بل كل الدلائل تؤكد انه قد يكون نقمة تقضي علينا إلى الأبد ..
ادواردو كاليانو أورد حالة عاشتها بوليفيا مع معادن الفضة وأخرى عاشها البرازيل مع معادن الذهب هي فعلا مرعبة، تقتضي وقفة تأمل مع سطور هذا الكتاب، لنفكر فيها قليلا..
نموذج بوتوزي في بوليفيا:
قبل مجيء الأوربيين المشئوم بالنسبة للهنود الحمر، أي السكان المحليين- وهنا شعب الانكا خاصة- اكتشف الهنود الحمر معدن الفضة في جبل بوتوزي، وأرادوا استغلاله، فكانوا يريدون به المزيد من التجميل لمعبد الشمس في عاصمتهم. الذهب والفضة بالنسبة للانكا لا يخرجان من حدود المملكة ولا يستعملان للتجارة فهما يصلحان فقط لعبادة الآلهة. عندما أراد الانكا استغلال ”الجبل الجميل“، وهذا هو الاسم الأصلي لبوتوزي، جاءهم صراخ له قوة الرعد من أعماق الجبل يقول: ” هذا ليس لكم، هذه الكنوز لمن سيأتون من بعيد“. هرب الهنود الحمر مذعورين وأعطوا للجبل الجميل اسما جديدا: بوتوزي، أي” ذو الصوت الرعدي أو المتفجر“.
الآتون من بعيد، أي الاسبان، لم يتأخروا كثيرا، فبعد اجتياحهم لأمريكا الجنوبية بقليل، باشروا استغلال الفضة، فتفجر الثراء الفاحش في بوتوزي كالنهر الهائج لدرجة أن الإمبراطور شارل كينت أعطى للقرية الناشئة في بداية القرن 16 كل أمارات التقدير بقرار يرفع بوتوزي إلى مرتبة ”مدينة إمبراطورية“ وأعطاها ميدالية تحمل العبارات التالية: ” أنا مدينة بوتوزي الغنية، كنز العالم، ملكة الجبال، ومحل حسد وغيرة الملوك“.
في قمة ازدهار بوتوزي كانت سنابك الخيل منعلة بالفضة. في أحد أعياد الميلاد أطليت شوارع المدينة بقطع الفضة. بعد إنشاء المدينة الجديدة علي سفح جبل بوتوزي بثمانية وعشرين سنة فقط كان سكانها يبلغون 120.000 نسمة وهو ما يساوي آنذاك سكان لندن، ويزيد على سكان اشبيلية ومدريد وروما وباريس. في القرن الموالي، أي السابع عشر، بلغ عدد سكانها 160.000 نسمة، فكانت من أعظم المدن وأغناها في العالم. قال دون كيشوت: “إن أعظم شكر يمكن أن يوجه إلى شيء هو أن يقال له أنه بوتوزي حقيقي”.
الجبل الذي كان على ارتفاع 5.000 متر كانت له جاذبية مذهلة، وصار الباحثون عن الكنوز يتوافدون علية كقطرات المطر الشديد. الحياة في السهل صعبة والطقس قاس، حيث البرد القارس يواجه كل قادم وكل مقيم كأنه ضريبة لا مفر منها.
مع سيلان الفضة تفجر في بوتوزي مجتمع غني وبدون أخلاق. في بداية القرن السابع عشر كانت للمدينة 36 كنيسة غاية في الروعة والجمال، وإلى جانبها 36 دار للألعاب و14 مدرسة للرقص و120 دار للدعارة.
مع منتصف نفس القرن كانت الفضة تمثل 99 بالمائة من الصادرات المعدنية لأمريكا الاسبانية، إلى درجة أن الفضة غيبت الذهب!
كانت أمريكا الجنوبية عبارة عن منجم كبير بوابته الرئيسية بوتوزي. زعم بعض الكتاب انه كان بإمكان اسبانيا أن تمد جسرا من قمة جبل بوتوزي إلى باب القصر الملكي في اسبانيا بمعدن الفضة الذي استغلته ثلاثة قرون.
كان تأثير انهيال معادن أمريكا الجنوبية على أوربا هو الذي مكن هذه الأخيرة من النمو، وفي كل الحالات كان له تأثير اكبر من انهيال كنوز الشرق على العالم اليوناني بعد انتصارات اسكندر الأعظم.
ولكن اسبانيا التي كانت تملك تلك الثروة وتستخرجها وتحفظها في بيت مال اشبيلية لم تستفد أكثر من مستعمراتها. كان يقال في القرن السابع عشر: إن اسبانيا مثل الفم الذي يتلقي الطعام فيهيئه للهضم، دون أن يحتفظ لنفسه إلا بطعم سريع الزوال مع بعض البقايا الذرية التي تتخلف بين الأسنان..الأسبان هم الذين يملكون البقرة ولكن آخرون هم الذين يشربون لبنها!
فسرعان ما أصبحت المملكة الاسبانية مدينة، وأضحت الخزينة في اشبيلية خاوية.. إذ القلة القليلة من تلك الفضة تتوجه إلى الدورة الاقتصادية الاسبانية وتتوجه إلى نمو الزراعة والصناعة. أما معظم تلك الثروة فيتوجه إلى بريطانيا وهولندا وغيرهما من الدول الأوربية لشراء المواد الضرورية والكمالية، ولتسديد ديون البابا الكاثوليكى في بناء بازلية روما العظيمة، كما استغرقت الحروب على جبهات متعددة حيزا وافرا من تلك الثروة!. والحق أن الذي استفاد بذكاء وبدون مشقة من فضة بوتوزي كانت الصناعات البريطانية والهولندية..
إن تدفق المال، بفضل معدن الفضة، المتيسر بسهولة، شكلت أداة تخدير للعقل الاسباني، فلم يقم اقتصادا قابلا للتطور والديمومة. انتكست الصناعة وبدأت تتلاشى، ومع تدفق الفضة من بوتوزي بدأت الزراعة أيضا تدهورها، التي كان طرد العرب قبل ذلك له تأثير عليه، لكن تأثير فضة بوتوزي أقوى من طرد العرب الذين بقوا في اسبانيا بعد 1492.هذا الطرد سنة 1609 تبعه تدهور الزراعة والعقلية الإنتاجية عموما، بفعل سهولة الثراء وتحول الاقتصاد الى اقتصاد طفيلي بعيدا عن حاجة الواقع ومتطلبات التطور في ذلك العصر الذي قطعت فيه دول أوربية كثيرة، خطوات جبارة نحو التقدم في مختلف الميادين.
عند وفاة شارل كينت عام 1558 كان في اشبيلية أكثر من 16.000 آلة نسيج. عند وفاة ابنه فيلبس الثاني، بعد ذلك بأربعين سنة، لم يبق إلا 400 آلة نسيج. هبط عدد رؤوس أغنام الأندلس من سبعة ملايين إلى مليونين. ببساطة لم يعد هناك من هو مستعد أو مهتم بأعمال غير مشرفة أو متعبة.
الإنتاج والنمو والتطور الاقتصادي لم يكن هو المجال الوحيد الذي أدى به الترف السهل إلى التقوقع، ففي منتصف القرن السادس عشر منع مرسوم ملكي استيراد الكتب الأجنبية ودراسة الطلاب الأسبان في الخارج. هبط عدد الطلاب الإجمالي في بضع عشرات سنين إلى النصف. أما عدد أدرة التعبد المسيحية فبلغ 9.000 ديرا كما تضاعف بسرعة مذهلة عدد رجال الدين والنبلاء الجدد، الغير منتجين. كان احد النبلاء، وهو دوق مدينة سيلى يملك 700 عامل منزلي، وكان لدوق أوسينا 300 عامل منزلي يكسيهم بثياب من طراز ملابس قيصر الروس، لكي يبرهن على عظمة نفسه وحقارة قيصر الروس!. في نهاية القرن السابع عشر كانت اسبانيا تضم 625.000 نبيل حرب، في حين عدد سكانها وصل إلي نصف ما كان عليه غداة تفجر فضة بوتوزي، وبالمقابل تضاعف عدد سكان بريطانيا في نفس الفترة.
في نهاية ذلك القرن كان الإفلاس شاملا: البطالة عامة، الأراضي الزراعية مهجورة، الصناعة في حالة خراب والعملة دونما قيمة والخزانة خاوية والسلطة المركزية غائبة في الولايات.
الفئة غير المنتجة استمرت في التزايد مع تناقص عدد السكان الإجمالي: فرجال الدين بلغ عددهم 200.000 ، وإبان طوفان الفضة القادم من مستعمراتها، أخلقت اسبانيا – أو خلق لها – مجال رحب غيبها عن التطور والتنافس مع الأمم الأوربية الأخرى في مجال الصناعة والزراعة والعلوم. فكان شغلها الشاغل الدفاع عن الدين الكاثوليكي الذي لم يعد مهددا بعد طرد العرب، وخاصة أن محيطها القريب من جميع الجهات كان على نفس المذهب، وان اقرب تواجد لللوثرية والكلفينية في هولندا وبريطانيا البعيدتان. فتكشف ذلك الدفاع على أنه محض قناع للوقوف ضد تيار التاريخ. فكانت اسبانيا نفسها هي الضحية حيث تدهورت حتى صارت في مؤخرة الدول الأوربية – مع توأمتها البرتغال – من ذلك الوقت حتى نهاية القرن العشرين.
ألهت اسبانيا نفسها في محاكم التفتيش وصرفت عليها بسخاء وسيرت الجيوش في كل أنحاء العالم المسيحي للقضاء على المنكرات والبدع والزندقة والنفاق والخروج على تعاليم الإنجيل الصحيحة. فأوقدت النيران لحرق الخارجين على الكاثوليكية أو المتهمين بالخروج عليها، وأضيف لوقود تلك “النيران المطهرة” الكتب العلمية والفلسفية التي لا تتناول الدين الكاثوليكي بإجلال أو تتجاهله. فكانت الكنيسة والعرش الملكي يرون فيها بجلاء آثار “ذيل الشيطان”، تقيدا بفتوى البابا:”كل تجديد ذنب، وكل ذنب يقود إلى الخلود في جهنم”. هكذا صرفت اسبانيا آخر فلس قادم من بوتوزي في تلك المعركة الوهمية.
إن بقاع العالم الأكثر تأثرا بالتخلف والفقر من بين المستعمرات القديمة، هي تلك التي كانت لها علاقات حميمة مع المستعمر، وعرفوا يوما ازدهارا عن طريق تصدير مواد أولية، وبمجرد تدهور ذلك المنتج بفعل نضوبه أو تعويضه بمنجم آخر أو مادة أخرى بديلة، فان المستعمر يترك المصدر بدون شفقة.. بوتوزي وبوليفيا بأكملها تعطي ذلك المثل بجلاء ، حيث السقوط إلى حد العدم!. بعد الازدهار المذهل، جاء القرن الثامن عشر منذرا بتدهور اقتصاد الفضة، فكانت الأمور بلغت مرحلة اللارجعة في اسبانيا وبوليفيا معا. في بداية القرن التاسع عشر استقلت بوليفيا.كان عدد سكانها يزيد على سكان الأرجنتين، إلا انه مع منتصف القرن العشرين كان سكان بوليفيا اقل ستة مرات من سكان الأرجنتين! أما بوتوزي فسكانها اليوم، عبارة عن ثلث سكانها قبل أربعة قرون.. الأغنياء هاجروا هم الأولين ثم الفقراء بعد ذلك. تركت المدينة للتاريخ زيادة على الكنائس المتدهورة والقصور المهجورة، عظام ثمانية ملايين من الهنود الحمر كانوا مكرهين على الأعمال الشاقة والمؤبدة في المناجم. كانت نساء الهنود الحمر تقتلن أبنائهن لكي يعفوهم من عذاب العمل في المناجم الذي كان مفروضا عليهم من الطفولة اليانعة حتى اللحد.
دولة بوليفيا اليوم، بلد من أكثر بلدان العالم فقرا، فقط بإمكانه أن يفخر بأنه كان السبب في ثراء الأمم الغنية، وما الفائدة؟! أما مدينته الشهيرة بوتوزي، فهي مدينة تعيش فقرا مدقعا في بلد فقير!.. قالت إحدى العجائز التي مازالت تسكنها: “مدينة أعطت اكبر عطية إلى العالم وهي تملك اقل شيء!” .. بوتوزي محكوم عليها بالبكاء الدائم على الأطلال . حظها البؤس والبرد القارس، فهي شاهد دائم وحي على بشاعة وظلم النظام الاقتصادي الجائر وبطش المجتمع الفاسد. حتى جبل بوتوزي نفسه تغير لونه وتغير ارتفاعه نتيجة لنهب قرون عدة، وللأنفاق التي خربته وعددها 5.000 نفق. مقابل جبل بوتوزي هناك جبل آخر تخرج من سفوحه شلالات عديدة. بالنسبة للهنود الحمر هذا الجبل هو الشاهد على النهب والظلم، وشلالاته ليست ماء وإنما هي دموع بكائه على بوتوزي وأهلها الأصليين، فسموه بلغتهم “الجبل الباكي”.
التدهور بلغ ببوتوزي مستوى غير مألوف تعدى الجانب المادي، فبعض الكنائس صارت تستعمل لأغراض بعيدة كل البعد عن الدين.. في فبراير 1970، أشهر الكنائس التي تحولت إلى سينما(!) كانت تعرض فيلما أمريكيا عنوانه أكثر تعبيرا من موسوعة بأكملها: “عالم مجنون، مجنون، مجنون..”…
نموذج أورو بريتو: “بوتوزي” الذهب في البرازيل:
البرتغاليون في البرازيل لم يعثروا في بداية عهدهم على معادن كريمة ولكن في فجر القرن الثامن عشر دخلت فجأة وبعنف في التاريخ منطقة ميناس جريس بذهبها الوافر. وفي هذا القرن وحده تجاوز إنتاج البرازيل من هذا المعدن الثمين إنتاج اسبانيا من كل مستعمراتها في القرنين السابقين. جاءوا، بدون تأخر أو تردد، من كل حدب وصوب أفواج المغامرين والباحثين عن الثروة والثراء السريع كأسراب الذباب على العسل. فليس من طبيعة البشر أن يكون الفضلاء وأصحاب القيم الرفيعة أول من يتنقل ويحوم حول الفريسة.
كان سكان البرازيل في ذلك الوقت أي في سنة 1700م لا يتجاوز 300.000 نسمة. بعد قرن، وفي نهاية عهد الذهب، زاد عدد السكان بثلاثة ملايين. كانت العاصمة باهيا في الشمال الشرقي ولكن عهد الذهب حول المحور الاقتصادي والسياسي للبلد نحو الجنوب وجعل من ميناء ريو دي جانيرو العاصمة الجديدة للبرازيل. وفي وسط تلك الفورة المعدنية خرجت مدن بأكملها من الأرض في حمى الثراء السهل والمفاجئ، وكما تصفها سلطة محلية في تقرير إلى العاصمة البرتغالية :”هي معاقل للمجرمين والأشرار والمتسكعين” .
كانت أوروبريتو إحدى هذه المدن الجديدة ونموذجها الأعلى. ولدت من انهيال الباحثين عن المعادن الثمينة القادمين من بعيد وقريب. وصفها في ذلك العهد كاتب برتغالي فقال أن قوة وثراء تجارها يفوق أمثالهم في لشبونه العاصمة البرتغالية ألف مرة. ووصفها أيضا أنها اكبر تجمع من النبلاء والمتعلمين ورجال الدين وهي القاعدة المتينة للعسكريين وهي رأس جسم أمريكا والجوهرة الثمينة للبرازيل. وقال كاتب آخر “هي بوتوزي الذهب”.
كانت الاستنكارات والاحتجاجات تتوارد بالدوام على البرتغال نتيجة للحياة المتفسخة التي يعيشها سكان تلك المدينة المعدنية المضطربة. كانت الثروات تتكون وتزول من يوم لآخر دون مقدمات أو أسباب مرئية.
ونتيجة للاضطراب العام، دخل رجال الكنيسة في اللعبة وانتهزوا حمايتهم لتهريب الذهب إلى درجة أن مراقبا في ذلك الوقت قال انه ليس في هذه الولاية رجل دين واحد مهتم بدينه!. لم يرى العرش البرتغالي بديلا من أن يحرم إقامة رجال الدين في الولاية الشاسعة كلها(مساحتها تفوق مساحة فرنسا، بينما البرازيل كله يفوق مساحة موريتانيا ثمان مرات) ومع ذلك انتشرت الكنائس العجيبة والنادرة البناء والمليئة بالتماثيل والتحف الذهبية واللوحات الثمينة.
تماما كما مثيلتها بوتوزى من قبل، أفرطت أوروبريتو في تبذير ثروتها المفاجئة وكأنها تمتثل أوامر صارمة في رمي ذهبها من النافذة، غير مبالية بالمستقبل. كانت بعض الاحتفالات – الكثيرة – تستمر لمدة أسبوع وتصرف فيها أموال طائلة، وكان كل شيء سببا للاحتفال حيث المدينة كلها في احتفال دائم. لم تكن الصناعة تطرف بالا لسكان المنطقة وكانوا يزدرون بعمل الأرض والزراعة والتنمية الحيوانية، لدرجة عرفت المدينة فيها، وهي في قمة ازدهارها، المجاعة حيث اضطر الأغنياء إلى أكل القطط والكلاب والفئران والنمل والعقاب، في الوقت الذي تغص دورهم بالذهب.
اما عمال الذهب في المناجم وهم من العبيد السود فكانوا في جحيم دائم من العمل الشاق الذي لا يعرف الانقطاع، تحت السوط. كان المرض بالنسبة لهم عبارة عن عناية إلاهية لأنه يقرب من الموت والخلاص من العذاب المؤبد. كان المراقبون على العبيد يتقاضون مكافأة ذهبية مقابل كل رأس عبد فار يقطعونه. كانت أنغولا تصدر إلى البرازيل عبيدا من أصل بانتو ولكن ملاك وأغنياء أورو بريتو يفضلون العبيد القادمين من شواطئ خليج غينيا لأنهم أكثر مناعة وتحملا ولهم موهبة سحرية في اكتشاف الذهب. وكان أيضا لكل شخص حر أو ذو شأن سيدة سوداء تفرحه وكان أهل أورو بريتو يفضلونهن من أهل شواطئ خليج غينيا. كان العبيد المستوردين يرغمون على الدخول في الدين المسيحي قبل عبور المحيط. وعند وصولهم البرازيل من واجبهم حضور الطقوس الكنسية مع أنه لا يسمح لهم بالدخول إلى قلب الكنيسة أو الجلوس على المقاعد.
ابتداء من القرن الثامن عشر هاجر الكثير من عمال المناجم الى جنوب الولاية. إن الحجارة التي كان الباحثون عن الذهب يلقونها في البداية غير مبالين، وهم ينقبون عن المعدن الأصفر، كانت في حقيقة الأمر من الماس. هذا ما تكشف بعد نصف قرن. إذا أصبحت ولاية ميناس جريس تهدي الماس، زيادة على الذهب بكل سخاء. فخرجت من الأرض ومن العدم، وبسرعة مذهلة، الى جانب أورو بريتو عاصمة الذهب، مدينة جديدة : تيجيكو عاصمة الحجارة الكريمة.
سكانها من المغامرين والأغنياء الجدد أصبحوا يتابعون أولا بأول الموضة في أوربا ويستوردون منها أثمن وأحسن ما تنتجه من الكماليات. فزاحمت أورو بريتو في ما كانت تبرع فيه من هذيان وجنون وتبذير ومجون وتفاهة. أعظم أغنياء تيجيكو، اوليفيرا، من على امرأة من عبيده بالحرية لأنها أصبحت سيدة فرحه، مع أنها كانت قبيحة ولها ولدين قبله. وكما أنها تحب البحر فقد حفر لها بحيرة اصطناعية كبيرة تتحمل ملاحة البواخر. فنظم من اجل تلك السيدة التافهة حفلات فاخرة يتخللها سيل من أرقى نوعيات المشروبات الروحية المستوردة من ما وراء البحار، زيادة على السهرات الراقصة والأمسيات المسرحية والموسيقية التي لا تنقطع.
مع بداية تدفق الذهب البرازيلي على البرتغال، الدولة المستعمرة، دق شبح شيطان باب القصر الملكي في لشبونة: فكان اسمه بريطانيا. كان بمثابة نذير شؤم في سلسلة طويلة من المآسي، والإهانة المعنوية والتخلف للبرتغال والبرازيل. فتح البرتغال، تحت الضغط، عند البداية، سوقه للمنتجات النسيجية البريطانية الصاعدة. لن تعوض ليترات من الخمور البرتغالية نسيج بريطانيا ومنتجاتها الأخرى، بل الذهب البرازيلي. ونتيجة لتلك الصفقة الخاسرة بقيت آلات النسيج البرتغالية متوقفة لأنها عاجزة عن تنافس المنتجات البريطانية المتطورة باستمرار. بعد ذلك بمدة، عندما بدأت إرهاصات صناعة نسيج برازيلية، أمرت المملكة البرتغالية، تحت إملاء بريطانيا، بحرق وحظر آلات النسيج البرازيلية.
كان الذهب البرازيلي يتوجه برمته الى بريطانيا وبعضه الى هولندا. وكما أن فضة بوتوزي كانت تمر فقط على الأراضي الاسبانية قبل وجهتها النهائية، فان ذهب البرازيل كان لا يزيد على توقف سريع أيضا في البرتغال. كانت الدولة المالكة مجرد وسيط. في نهاية الأمر، الذهب يسقط في جيوب الانكليز وخزائن بنوكهم. بسياسة ماكرة ومصحوبة بالتهديدات المبطنة أحيانا والصريحة تارة أخرى، سيطرت بريطانيا على البرتغال، دون سلبيات الاحتلال المباشر. كان الانكليز مسيطرين على الاقتصاد البرتغالي، والبرتغاليون لا ينتجون شيئا الى درجة أن ثياب العبيد الذين يعملون في مناجم الذهب بالبرازيل كانت تأتيهم من بريطانيا، التي تستعمل ذهب البرازيل، شبه المجاني، لشراء حاجاتها وتمكنت من المزيد من الاستثمارات في صناعتها ومن التحديثات التكنولوجية السريعة والفعالة بمفعول تلك المودة التاريخية البرتغالية. كان يصل الى لندن أسبوعيا من الذهب البرازيلي ما قدره خمسة وعشرون ألف ليرة. بدون تراكم هذا الرصيد العجيب لم يكن في استطاعة بريطانيا أن تواجه في ما بعد حروب نابليون.
فما عدى الكنائس والتحف الفنية لم يبق شيء على ارض البرازيل، بعد انقراض الذهب. فسقطت ولاية ميناس جريس الذهبية في موجة عميقة من التدهور والخراب. إن المناطق المعدنية محكوم عليها في نهاية المطاف، بدون رجعة، بالفقر والعزلة، وقدرها أن تبقى تحاول انتزاع معاش رديء من أراضي فقيرة!. ذلك هو حظ ولاية ميناس جريس الشاسعة. خلفت الزراعة المعاشية الاقتصاد المنجمي، وقبعت ميناس جريس في التقوقع والتدهور. ومن زار تلك الولاية في الآونة الأخيرة، سيرى مساكن متحطمة وقرى بدون ماء ولا كهرباء، وبنات لا تزيد أعمارهن على 13 سنة يمتهن في الشوارع “أقدم مهنة في الدنيا”، وسيرى أيضا على الطرقات طوابير من الجائعين والهائمين والمجانين!.
قال الكاتب كورسكس إن ولاية ميناس جريس لها قلب من ذهب في صدر من حديد. فعلا اكتشف الحديد في الولاية بكميات هائلة. ولكن هذا الحديد في أيدي شركات أمريكية ، ولم يغير شيئا في حياة المواطنين. لن يترك الحديد شيئا وراءه كما لم يترك الذهب شيئا. لن يترك إلا آثار الجرافات والهفوات السحيقة والقرى المهجورة.
خلفت الذكريات الأليمة لذلك الضياع حكمة: “الجد تاجر والأب من ملاك الأرض والابن متسول”. لم يفهم سكان ميناس جريس ما جرى لهم. لم يفهموا مسألة بسيطة وأساسية تفسر كل شيء: توزيع العمل بين الفارس والفرس !
توجهوا بعكس ذلك الى مخبأ اليأس: الخرافة. يتعاطى سكان ميناس جريس هذه الحكاية التي تزيد من اضطراب نوم الجياع. يقولون إن كنيسة مهجورة اسمها كنيسة الرحمة، مازال عمال المناجم الموتى يرتادونها في الليالي القارسة البرد والممطرة ويقيمون فيها قداسا وان الراهب الذي يقود الصلاة عندما يرفع رأسه وذراعيه، كما تقتضي الطقوس، يتكشف أن رأسه رأس ميت…
وصف دقيق لتأثير هذه الثروات التي تجلب الحظ والقوة والسعادة للجميع ما عدى أهلها الحقيقيين.. هؤلاء الذين كانت لهم مصدر بؤس ابدي، ولعنة أصابت الأرض وساكنيها..
إن تأثير الثروة المتأتية من تدفق الثروات بسهولة من مكامنها الأرضية يشكل خطرا حقيقيا على مسار تقدم الشعوب وتطورها عبر سيرورة تطورية يشكل وعي الواقع والتعامل معه عبر نسق من الرؤى والبحث والفعل الخلاق ، بعيدا عن التوكل والكسل وتوابعهم المدمرة.
هذا هو مصدر الخوف على البلد من ثروة لا تستعين بوعي حقيقي وبعد نظر وتخطيط.. فهل يمكننا أن نستفيد ولا نتضرر؟ وهل يمكن أن نثبت أن الثروة قد تكون نفحة مباركة، تقدم ولا تأخر.. تحيي ولا تميت؟
ما أحوجنا الى أن يكون الخوف في غير محله! وأكثر من ذلك أن تكون مقولة المهدي المنجرة في غير محلها.
محمد يحظيه ولد أبريد الليل